بلاغة الأنوثة وطقوس الغياب
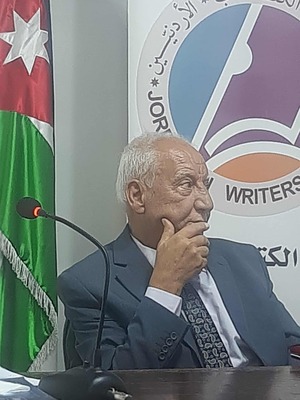
قراءة نفسية وجمالية في ديوان قصير فستان صبري للشاعرة ميّادة مهنّا سليمان
في ديوانها «قصير فستان صبري»، تفتح الشاعرة ميّادة مهنّا سليمان باب الأنوثة على مصراعيه، لا لتحتفي بالزينة أو الغواية، بل لتجعل من الأنوثة خطابًا شعريًّا يُعيد تعريف الألم والحنين والغياب. إنها تكتب من قلب التجربة، من منطقةٍ يلتقي فيها الحبّ بالموت، والصبر بالجمال، فيتحوّل الحزن إلى طقسٍ جماليٍّ يمارس فيه الشعر دوره العلاجيّ بوصفه اعترافًا وتطهّرًا معًا. في هذه القراءة التي تتوسّل المنهج النفسيّ الجماليّ، نحاول النفاذ إلى ما وراء العاطفة السطحية لاكتناه بلاغة الأنوثة في نصٍّ يطرّز الغياب خيوطًا من حرير، ويحوّل الجرح إلى فستانٍ من الضوء، يلمع كلما لامسته يد القصيدة.
ديوان " قصير فستان صبري " للشاعرة ميّادة مهنّا سليمان عملٌ شعريّ يفيضُ أنوثةً ووجدانًا، ويقف في منطقةٍ حسّاسةٍ بين الشعر والرثاء، بين البوح والكتابة كفعل مقاومة للحزن. من خلال لغتها الممشوقة وعاطفتها المتوترة، تنسج الشاعرة من مفردةٍ بسيطة مثل الفستان عالماً دلاليّاً متكاملًا، تحيله إلى قماشةٍ من الحنين، تخيط عليه مشاعرها بالإبرة والدمع معًا. فالنسيج هنا ليس قماشا حسّيا بل حروفا من لهفةٍ وأنين، والفستان هو استعارة الذات في أكثر تجلياتها هشاشة واحتراقًا.
ينطلق الديوان من نبرة أنثوية عارفة بسرّ اللغة وسرّ الحبّ وسرّ الفقد، أنثى تُخاطب الغياب وكأنه كائنٌ ماثلٌ في المرآة، وتحوّل مناجاتها له إلى ضربٍ من الطقس الشعري المقدّس؛ فكلّ قصيدةٍ صلاة، وكلّ سطرٍ محاولةٌ لتطويل فستان الصبر الذي قصّرَهُ الغياب. وبهذا المنظور يمكن مقاربة الديوان بالمنهج النفسي الرمزي، إذ يتبدّى النصّ كرحلة علاجٍ بالكتابة، تعيد فيها الشاعرة ترتيب علاقتها بالذات وبالآخر وبالزمن، عبر رموزٍ ذات حمولة وجدانية مكثّفة: الفستان، القميص، المرآة، المطر، الورد، القهوة، الصباح، الحلم... وكلها تتوزع على خريطة عاطفية واحدة هي خريطة الحبّ في مواجهة الفقد.
لغة ميادة سليمان لغة مترفة بالزخرف الحسيّ، لكنها لا تسقط في الزينة المجانية، بل تستثمر الملموس لتصل إلى المعنويّ. فهي حين تقول:
سَأخِيطُ من كَلِمَاتِي لكَ
قَميصَ عِشقٍ
لونُهُ يَاسَمينُ قَلبَينَا
أكمَامُهُ أَشوَاقٌ
أزرَارُهُ حُروفُ حُبٍّ قُلتَهَا لِي
وَربطَةُ عُنُقِهِ
قُبلةٌ حَمرَاءُ
تجعل من الخياطة فعلاً كتابيًا ومن القميص نصًّا، ومن الورد ذاكرةً تلتفّ على الجسد واللغة في آن. إنّ الشعر عندها ليس وصفًا للعاطفة، بل هو اشتغال فنيّ على الجمال بوصفه خلاصًا. لذلك لا ينفصل البعد الإيروسيّ عن البعد الروحي، ولا الحنين عن الإبداع؛ فكلّ تفصيلة جسدية تنقلب رمزًا ميتافيزيقيا للحياة بعد الموت، والوصال بعد الفقد، والعطر بعد الرماد.
يتوزع الديوان على ثلاثة أقسام عنونتها بـ«الفستان الأول»، «الفستان الثاني»، «الفستان الثالث»، وهي ليست تقسيمات شكلية بل محطات في تطور الحالة الشعورية: من اللهفة الأولى إلى نضج الوجع إلى التصالح مع الذاكرة. في القسم الأول نرى الشاعرة في ذروة الوجد الأنثوي، تكتب من قلب اللهيب، تتأنق باللغة كما تتأنق العاشقة قبل اللقاء، تلبس الكلمات كما تلبس الفستان القصير لتغوي الحياة نفسها. أما في القسم الثاني فيتسرب الحزن ببطءٍ إلى نسيج النص، وتبدأ المفردات تكتسب ثقلها الوجداني؛ هنا تصير المرآة رفيقة الوحدة، والقهوة بديلاً عن الشفاه، والانتظار طقسًا يوميًّا. وفي القسم الثالث تبلغ التجربة ذروتها التأملية: يصبح الشعر مرثية للحبّ واحتفاءً به معًا، ويختلط الموت بالميلاد في مشهدٍ لغويٍّ مهيب، حيث تقول: «قصيرٌ جدًّا فستان صبري إذا افترقنا»، لتجعل من الصبر جسدًا يتعرّى أمام العاصفة.
الصورة الشعرية في هذا الديوان تقوم على التوليف بين البصر والوجدان، فهي ضوئية على الرغم من حزنها، مشبعة بالألوان: الفوشيا، الأخضر، الأزرق، الورد، كلّها تشكّل طيفًا من الحنين المتأنّق. الإيقاع بدوره هادئ متدفق، يتناوب بين الجملة القصيرة التي تشبه النبضة، والعبارة الطويلة التي تشبه الزفرة. هناك موسيقى داخلية تعتمد التكرار والالتفات والمقابلة، فينشأ عن ذلك نسيج غنائيّ شفيف يحمل بصمةً نزارية في البوح وجرأة الجسد، لكنه يحتفظ بروحٍ خاصةٍ هي روح المرأة التي تحبّ من وراء الموت.
وإذا أردنا أن نقرأ الديوان بوصفه مرآةً لرحلة الشفاء عبر الجمال، فسنجد أن الشاعرة لا تستسلم للرثاء، بل تخلق بديلاً وجوديًا عنه: الكتابة. إنها تحوّل الوجع إلى أناقةٍ لغوية، والفقد إلى قصيدةٍ راقصة على حافة الدموع، حتى يصبح الشعر لديها محاولةً لترويض الغياب لا البكاء عليه. فميّادة سليمان لا تنوح، بل تطرّز النواح بوردٍ من الإيقاع، وتجعل من كل خسارة ثوبًا جديدًا للحياة.
إنّ «قصير فستان صبري» ليس مجرد ديوان حبّ، بل هو سيرة أنثى تنسج ذاتها من قماشة اللغة، أنثى تواجه وحدتها بعطرها، وتواجه الموت بجمالها، وتقول لنا إن القصيدة يمكن أن تكون فستانًا تلبسه الروح لتغطي عري الفقد. في هذا المزيج من الأنوثة والعمق، من الغناء والدمع، تتجلّى الشاعرة لا كصوتٍ فرديٍّ فحسب، بل كرمزٍ لجمالٍ يقاوم الانطفاء، كمن تُشعل شمعةً في غرفة الغياب وتقول للظلال: «ما زلتُ هنا... وما زال فستاني قصيرًا على صبرٍ طال".
في ختام هذا السفر الشعريّ الموشّى بالعطر والدمع، يتبدّى ديوان «قصير فستان صبري» كحديقةٍ أنثويةٍ تُثمر من الحزن جمالًا، ومن الغياب حضورًا. لقد استطاعت ميّادة مهنّا سليمان أن تُحوّل التجربة الشخصية إلى كونٍ رمزيٍّ نابضٍ بالإنسانية، وأن تكتب وجعها بمدادٍ من الضوء لا من العتمة. في لغتها تتجاور الرهافة والعنفوان، وتتعانق الأنوثة بالحكمة، فيغدو الشعر مرآةً لروحٍ تُقاوم الفقد بجمالٍ واعٍ بذاته، لا ينكسر ولا يستسلم. إن هذا الديوان يرسّخ صوت الشاعرة في المشهد الشعريّ العربيّ كصوتٍ أنثويٍّ مميّز يكتب الجرح بيدٍ من حرير، ويُعلّم القارئ أن القصيدة يمكن أن تكون معراجًا نحو الشفاء، وأن الجمال ـ مهما انكسر ـ يظلّ أصدق أشكال المقاومة.















